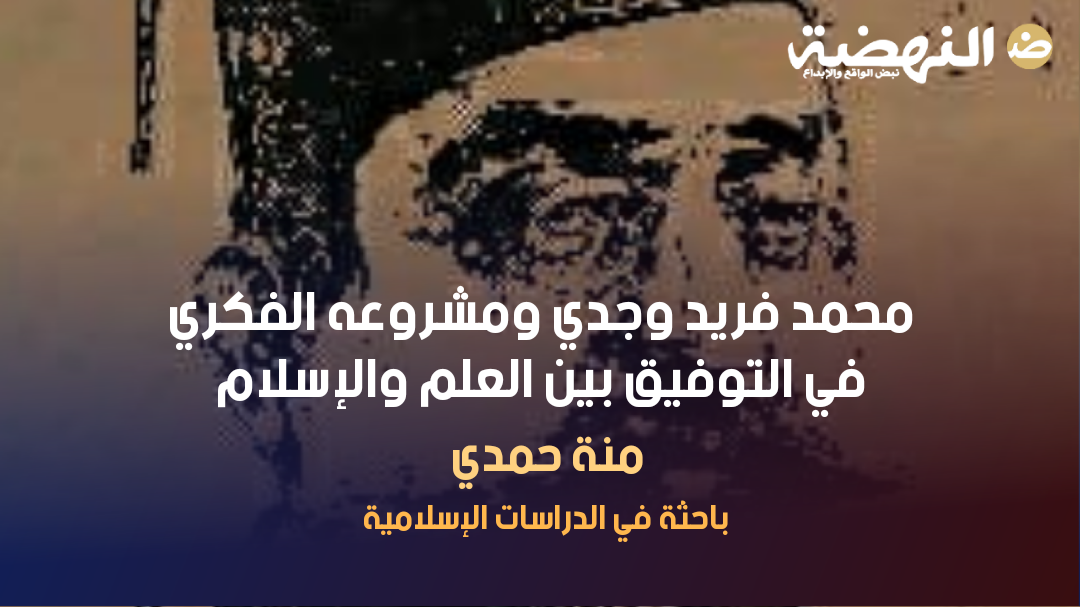بقلم الكاتبة المصرية، منة حمدي
يقول العقاد في كتابه رجال عرفتهم:
«هو فريد عصره غير مدافع، وتلك كلمة مألوفة ولطالما قيلت عن عشرات من حملة الأقلام في عصر واحد، كلهم فريد عصره، وكلهم واحد من جماعة تعد بالعشرات، فلا معنى لها في باب العدد، ولا في باب الصفات، ولا سيما صفات الرجحان والامتياز، إلا أننا نقولها اليوم عن فريد وجدي لنعيد إليها معناها الذي يصدق على الصفة حرفاً حرفاً، ولا ينحرف عنها كثيراً أو قليلاً، حتى في لغة المجاز».[1]
إنه الأستاذ «محمد فريد وجدي» كاتب ومفكر إسلامي ذات أصول شركسية ولد في مدينة الإسكندرية بمصر سنة 1878 م (1295هـ) وتوفى بالقاهرة سنة 1954م (1373هـ). عمل على تحرير مجلة الأزهر لبضع وعشر سنوات، له الكثير من المؤلفات ذات طابع ديني وفلسفي.
من أبرز ما اشتهر به محمد فريد وجدي «دائرة معارف القرن الرَّابع عشر الهجري- العشرين الميلادي» وقد ألَّف هذه الموسوعة في عشر سنين، وطُبِعت في عشرة مجلدات، و8416 صفحة. وله العديد من المؤلَّفات، منها: «المدَنِيَّة والإسلام»، وقد ألَّف هذا الكتابَ وهو في عشرين من عمره، وألَّفه بالفرنسيَّة، ثم تَمَّت ترجمته للعربية وغيرها.
كما ألف كتاب «المرأة المسلمة» للردِّ على أفكار قاسم أمين في كتابه «المرأة الجديدة» الَّتي كانت تُخالف الإسلام، وقام بالردِّ على «طه حسين» في كتاب «نَقْد كتاب الشِّعر الجاهلي». كما له كتاب مهم بعنوان «صفوة العهدان» في تفسير القرآن أعيد طبعه عدة مرات، وله كتاب رائع في السيرة «السيرة المحمدية تحت ضوء الفهم والفلسفة»، وله كتاب في شرح مبادئ الإسلام ورد الشبهات عنه اسمه «الإسلام دين عام خالد». كما أنه أصدر مجلة خاصة به تحت عنوان «مجلة الحياة» خصصها للرد على الشبهات حول الإسلام.
هنا بدأت الحكاية…
تزلزلت عقيدتي، وشرع الشك يتسرب إلى نفسي، حتى صرتُ لا أرتاحُ إلى رأيٍ واحدٍ يتضمنه كتابٌ، ولا أقتصرُ على فكرة معينة يجتهد بعض العلماء في إثباتها بما عُرف من قوة الحجة وساطع البرهان.
يقول الأستاذ فريد وجدي عن بداية تشكيل فكره:
كان أهم ما وجهني إلى البحث في العلوم الدينية: حادث الشك في العقيدة الذي أدى بي إلى الشك في كل شيء، حتى الدين وعلومه، فقد كنتُ في سن السادسة عشرة، طالباً في المدرسة التحضيرية والثانوية التي حصلتُ منها على شهادة الدراسة الثانوية باللغة الفرنسية، وكان أبي – مصطفى وجدي- موظفاً بالحكومة المصرية، وحدث وقتئذ أن اختير وكيلاً لمحافظة دمياط، فكان لابد من انتقالي مع عائلتي إلى هذه المدينة التي اشتهر أهلُها بالتفقه في الدين وميلهم إلى العلوم الدينية والآداب.
ولَمَّا نزلنا هذه المدينة مع أبي : أقبل علماؤها يرحبون به، فكان يجتمع في دارنا عددٌ كبيرٌ منهم، وكانت تدور أثناء المجلس عدة نقاشات دينية: وجدتُّ فيها مجالاً للبحث والتفكير، غير أنني كلما كنت أناقش أحد العلماء في مسألة تتعلق بالخلق والكون: أسرع “أبي” إلى قفل باب المناقشة، وأمرني بألا أخوضَ في المسائل الدينية أو أن أبدي رأياً فيها!
فكنتُ أَمْتَعِضُ وأَغضب، وأرى ذلك حجراً على العقل بلا مُسَوِّغٍ. وأخذتُ أبحثُ عن السبب الذي أدى بهؤلاء العلماء إلى الجمود، وقلتُ في نفسي: إنه لابد أن يكون ما يدرسونه من الكتب عقيماً. ومن هنا، تزلزلت عقيدتي، وشرع الشك يتسرب إلى نفسي، حتى صرتُ لا أرتاحُ إلى رأيٍ واحدٍ يتضمنه كتابٌ، ولا أقتصرُ على فكرة معينة يجتهد بعض العلماء في إثباتها بما عُرف من قوة الحجة وساطع البرهان.
وجعلتُ أتناول بالقراءة والدرس جميعَ ما أحصل عليه من الكتب الدينية والكونية والفلسفية والاجتماعية، وسائر كتب علم النفس، وعكفتُ على دراستها عدة سنواتٍ، فاكتسبتُ علماً غزيراً، واتسع أمامي أفق التفكير، وجالَ فكري جولاتٍ في الكائنات أفادتني فيما أتناوله بالدرس والبحث، حتى صرتُ لا أقتنعُ بفكرةٍ دون أن أُعْنَى بدرسها وتمحيصها، معتمداً في ذلك على تجاربي الكثيرة، وبحوثي المتنوعة، وتفكيري الذاتي.
ولقد أفادني ذلك استقلالاً في الفكر، واعتماداً على النفس، ورغبةً قويةً في استيعاب كل ما يقع بيدي من الكتب – على أنواعها- بصبرٍ وجَلَدٍ، كما استفدتُّ صحةَ البحثِ، حتى زال الشك عني وارتاحت نفسي إلى إيمان ديني ثابت.[2]
نلحظ هنا أن أول ما لفت انتباهه في ذلك الحين التعارض بين إسلام أولئك الشيوخ وبين المنهج العلمي الذي قرأه هو، فلم يجد أمامه سوى طريقين: إما أن يكون الدين هو حقًا مايعرضه هؤلاء الشيوخ فيكون باطلًا ضعيف الحجة، وإما أن الدين غير ذلك، فبدأ طريقه ملتمسًا الدين بين أروقة الكتب والمصادر، فتبين له عقم تفكير هؤلاء الشيوخ وسوء فهمهم للدين، مما دفعه إلى الاستزادة وعدم الاكتفاء فمضى ملتمسًا بقراءاته الحقائق الدينية في كل مجال.
“إن الأوربيين معذورون في تصديق التُّهَمِ ضد الإسلام والمسلمين، ماداموا لا يَرَوْن أمام أعينهم من مظاهر الدين غير البدع التي اخترعها صغارُ العقول، وزادوا أشكالاً من الأوهام والأباطيل تَنْفِرُ منها الطباعُ البشرية وتُنَافِي أصولَ المدنية”
بعد تلك الواقعة سيطرت عليه فكرة الاتجاه بالكتابة عن الإسلام إلى الأوربيين، سعيًا منه لتصحيح صورة الإسلام في أعينهم، إذ بدا له أنهم لا يعرفون عن دين الإسلام إلا ما يرونه أمام أعينهم كل يوم من الجمود والبدع واقتراف أشد المنكرات المنافية للأدب والعقل!
لم يجد بدٌ من حمل تلك المسؤولية في تصحيح هذه الصورة أمام الغرب، وجلاؤها مبرأةَ مما لحق بها، فعهد إلى نفسه ألا يضني جهدًا والا يترك بابًا في هذا إلا وطرقه، في سبيل إظهار الإسلام على حقيقته أمام الأوروبيين، مع العزم على محو البدع التي غص بها الفكر الإسلامي.
فيحكي الأستاذ وجدي عن تجربته ويقول:
«لم أر أفضل لخدمة الدين والوطن من هذه الوجهة؛ فثابرتُ من حينها، بهمة لا تعرف الملل، على درس ما يؤهلني إلى فهم حقيقة الإسلام، حتى آنست من نفسي القوة على القيام ببعض هذا الواجب فابتدأتُ أعمالى بتأليف كتاب باللغة الفرنسية، نقّحت فيه عن الإسلام كل تهمة ألحقها به المفترون؛ وأثبت بالأدلة الحسية، وبالإستناد على البداءة العلمية، أن الإسلام روح المدنية الحقيقية، وعين أمينة النفس البشرية ، ونهاية ما تری إليه القوة العقلية»
قضى وجدي بقية حياته منافحًا للمادية والماديين فكان مترصدًا لكل ما يصدر من الكتب التي تروج للنظرية الداروينية ليقوم بتفحصها والرد عليها، فكتب «على أطلال المذهب المادي» في أربعة أجزاء محاولًا هدم كل ما قاله «أصحاب نظرية التطور» موضحًا حقيقة الصلة بين العلم والدين.
بدائع الأكوان.. الملامح الأولى لشخصية فريد وجدي
تظهر الملامح الأولى لشخصية كاتبنا في نتاجه الفكري الأول متمثلة في كتاب «الفلسفة الحقة في بدائع الأكوان» جعل فيه كلماته تنتظم لبيان أسرار الوجود من خلال دراسة الكون والنظر إلى الكائنات، مما مكنا من استنباط نوع التأملات وتوجه القراءات التي كانت تستهويه وتسيطر عليه في مقتبل شبابه.[3]
لمسنا من خلال كتابه الأول أننا أمام شاب عالم باحث عن الحقيقة لا يفتأ أن ينقّب عنها في أي طريق وبأي وسيلة. فقد وجدناه يتحدث عن الإبداع الكوني وعجز العلماء عن وصفه وقصورهم عن إدراكه قائلًا:
«هؤلاء العلماء هم أكثر الناس لذة، وأوفرهم حظًا، وأغزهم عقلًا، وأفضلهم نبلًا، يرى الواحد منهم النملة سائرة على أديم الأرض، فيكون نظره إليها، ألذ له من اجتلاء خطرات الغادات في الخمائل النضرات، وإن سمع زمجرة الرعد وقواصف الرياح يهتز لحكمتها طربًا، ولا طربه من سماع رنات العيدان، فإن خيرت أحدهم بين ملء الأرض ذهبًا مع صيرورته من ذوي العقول الساذجة وبين بقائه على حاله مع الفقر ، لرضى بالثاني رضى لا يشوبه ندم ولا يصحبه سدم، مع هربه من الأول ولا هربه من المصاب بالتيفود، فهو على حاله لا يعلم قدرها إلا هو ومن على شاكلته».[4]
أولى خطوات معركته
بعد صدور كتابه الأول «بدائع الأكوان» بثلاث سنوات، صدر كتابه الثاني وهو يمثل أولى خطوات فريد وجدي في جهاده الديني وطريقه نحو فهم الدين على حقيقته، وتبيين صورته الصحيحة مبرأً من البدع والخرافات، فصدر كتابه بعنوان «الإسلام والمدنية».
فيذكر في مقدمة الكتاب:
«إن غرضي الوحيد من هذا العمل هو إقامة الحجة العلمية على أن دين الإسلام ليس الدين الذي يتناساه ذووه، أو يلوي الكشح عنه متبعوه، وأنه ليس بالدين الذي تعارضه العلوم العصرية والحقائق الفلسفية، بل هي ما تزيده تثبيتًا وتمكينًا، وتزيد متبعيه إيمانًا ويقينًا، أنه كان يجب أن يجد من طلاب العلوم الجديدة أنصارًا أولي قوة ومكانة، لا أن يرى منهم إعراضًا وابتعادًا يدلان على ما الإسلام بريء منه، وبعيد بعد السماء عنه».[5]
كانت فلسفته في هذا الكتاب هي عرض الإسلام بصورة تواكب العلم الحديث، ولا يأباها علمائه المحدثون، فكان يحرص في كتابه هذا على عرض الإسلام بشكل يجذب إليه طلاب العلم الحديث بشغف واهتمام. وكل ما قام به في سبيل هذا هو عرض الإسلام في صورته الأولية، وتجريده من ركام الأمم التي دخلته، وما اختلط به من المناهج الفلسفية.[6]
وما نلحظه من منهج فريد وجدي في هذا الكتاب وغيره هو محاولاته في وضع المبادئ الأولية التي قام عليها الإسلام والتعاليم التي جاء بها في ثوب العلوم المعاصرة، الأمر أشبه بأنه كان يحاول التفتيش على المبادئ الأصولية للإسلام في كتب العلم، فكان يرى في ذلك من القوة لإقناع الأوروبيين، ومن اغترّ من المسلمين بهم.
فنجده عندما تحدث عن ماهية الدين، قال:
«نحن هنا، قبل أن نتكلم عن ماهية الدين بالمعنى المراد للإسلام، يجب علينا أن نتكلم عن ما يفهمه علماء أوروبا من هذه اللفظة!».
وبالفعل بدأ بحثه عن ماهية الدين عند علماء أوروبا، مما أودى به إلى الديانة الطبيعية المسيطرة على أوروبا حينذاك، وعمل على استخلاص مبادئها في سبيل إظهار التقابل بينها وبين مبادئ الدين الإسلامي.
نظرته إلى العلم
يمكننا القول أنه نتيجة ما تعرض له من الشك في مقتبل عمره، والذي بدوره دفعه إلى قراءة كتب الدين في جميع اتجاهاتها، مع قراءة كل ما يتصل بها، وبحث المسائل الدينية من كل جوانبها، جعلته لا يقنع برأي غير مقتصرًا بقول أو مكتفيًا بما يعرض عليه من جهة واحدة، داعيًا إلى التوقف عن تقديس العلم، والجزم في مسائله وكأنه قد قال كلمته الأخيرة، منددًا بذلك على ممن يقفون على الظواهر ويقتنعون بالقشور، فيصدرون أحكامهم العلمية في صورة قاطعة لا تقبل النقاش، إذ يقول:
«قد جرى كل علماء الدنيا على عدم الاغترار بالقشر عن اللباب، وصاروا ينظرون للشيء مريدين معرفة كننه لا حقيقته فقط، أما الذين قرأوا كتابًا أو كتابين وتعلموا بعض الاصطلاحات الفنية وطُمس على بصيرتهم، فإنهم ينظرون للطبيعة نظر العميان فلا يرون فيها شيئًا من الأشياء إلا وجدوا له في مخيلتهم كلامًا محفوظًاقرأوه في كتبهم. فلما تحصل لهم ذلك إذا هم يغترون بأنفسهم، ويزعمون أنهم أساطين الطبيعة وعمادها، فنريهم بفكرتهم الجامدة، أن الطبيعة ليست بغريبة التركيب لا لأنهم عرفوا كل شيء فيها. فمثل هؤلاء كمثل المغتربين بالسراب الكاذب الذي لا يغني عن المال فتيلا، لو سألت أحدهم ما الماء؟! لقال بملء فيه: أكسجين وهيدروجين فقط! كأنه ينص على أن المادتين فقط هما عنصرا الماء، ومع أن حضرته لا يدري أنه ربما وقع فيما كان واقعًا فيه أسلافنا من اعتبارهم الماء عنصرًا واحدًا، وهل لديه دليل على أن الأكسجين جسم بسيط؟ وما المانع من أنه يكون مركبًا من جملة عناصر تظهرها الآلات المستقبلة فيما بعد!»[7]
ولكنه لم يلبث وأن تطورت نظرته إلى العلم، إذ نرى أنه مع تقدمه مسيرته وأبحاثه نجده يدعو إلى التمسك بالعلم وإعطاءه أولوية فيقول:
العلم هو الباعث الأول للاعتقاد والإيمان، وأكبر سائق إليه، وأن الإنسان كلما ازداد علمًا ازداد يقينًا
كما يقول مقدمة كتابه الإسلام في عصر العلم:
ولم يسقط المسلمون إلى ما عليه الآن إلا بلوهم عن العلم كشحةً، وضربهم عن الخوض في مناحيه صفحة. ألم تر أن في كل دور من أدوار العلم كتبت المسلمين اتخذت أرقى مدركاته سلاحا للدفاع عن الإسلام وتأييده وجعلت أعضل مسألة آلة لتشييد صرحه وتوطيده .
ويقول عنه د/ محمد طه الحاجري في كتابه محمد فريد وجدي حياته وأثاره:
وكأنه كان يتمثل -وهو مقبل على تأليف كتاب الإسلام في عصر العلم- صورة متکلمی الإسلام الذين اقتفوا أثر المعتزلة الأوائل، والذين يصفهم الجاحظ، بقوله: والمعتزلة يريدون أن يعرفوا كل شيء ويأبى الله ذلك، والذين كانوا يلتمسون المعرفة من كل سبيل. وكانوا يتخذون من معارفهم الواسعة وثقافات عصرهم. ومن دراساتهم المستقصية، أداة يؤيدون بها مذهبهم، ويدفعون بها أعداء الدين ويجادلون بها خصومهم.
الأبحاث الروحية
يُشهد لفريد وجدي بالسبق في طرق مجال الأبحاث الروحية في الوقت الذي كانت الجامعات الإسلامية تعد الحديث في الروحانيات من قبيل الخرافة؛ مما جعل البعض ينكر عليه هذا الاتجاه. ولكنه لم يتأثر بأي نقد واستمر في طرق هذا المجال، موضحًا المرامي الباعثة على نهوض البحوث الروحية في وجوه الشكوك المتلاحقة وباذلًا جهده في إثبات العالم الروحي ليس فقط ليعتقد الناس ببقاء الروح بل ليدعوهم لصلاح أمرهم في الدنيا.
المدنية عند فريد وجدي
«ونَحْن معشرَ المسلمين نعلم أنَّ الإسلام ينطبق على المثل الأعلى للمدنيَّة، ويزيد عليه سُموًّا، فعلينا وحْدَنا التدليل على ذلك، والقيام بِنَشره في الآفاق».[8]
هل يمكن أن تتَّفِق المدَنِيَّة والدِّين؟ وهل المدنيةُ بطبيعتها تُنافي الدِّين؟
يوضِّح الأستاذ وجدي في كتابه “مهمة الإسلام في العالم” أنَّ المدنيَّة التي يعدُّها الناس اليومَ أزهى المدَنيَّات وهي المدَنِية الغربية، لم تَضْمن لأهلها راحة البال، وهناء النَّفْس، ولكنَّها اندفعت بهم إلى صراعات داميةٍ، وحروب مُبيدة، حتَّى أصبحَتْ في أمسِّ الحاجة إلى التقويم والتَّصحيح.
فيقول: إنَّ أصحاب هذه المدَنِيَّة لا يُنكرون نُقْصانها وحاجتَها إلى الإضافات الكثيرة، وأنَّهم يتطلَّبون مثلاً أعلى يقيهم من هذا الانحلال والنُّقصان، ولا شكَّ أن هذا المثل الأعلى يُوجَد في الدِّين الذي يُعلِّم أصحابه الرحمة والإيثار، والبَذْل والعطاء.
إلاَّ أن أصحاب هذه المدنية يدَّعون أنَّ الأديان تبثُّ في مُقابل هذه المزايا عقائدَ تنافي أوليَّات العقل، وبداهات النَّظر، وتُعادي العلم، وتقيِّد الحريات، وقد تأثَّروا من هذه المَشاهد التاريخيَّة، حتى أصبحوا يظنُّون أنه لا يوجد دينٌ على وجه الأرض يخلو من هذه العقبات؛ فإذا ما أمكن إقامة الدَّليل على أنَّ واحدًا من الأديان تنطبق أصوله على مميزات المثَلِ الأعلى للمدنيَّة، فلا يوجد ما يَمْنع من إعلان اتِّفاق الدِّين الحقِّ والمدنية.
إذن ما الذي أوجد هذه الهوَّة السحيقة بين الدِّين والمدنيَّة في نظر بعض الآخِذين بمبادئ الحياة العصرية اليوم؟
أجاب فريد وجدي عن هذا التَّساؤل بقوله: أوجدها خطَأٌ جلَل، تسرَّب إلى عقولهم، ولم يَفْطنوا إليه، وهو أنَّهم خلَطوا بين المدنيَّة بمعناها الصحيح، وبين ما أوجده أهل الإباحة من التَّعديات المُنوَّعة على العلم والأخلاق، تحت ظلِّ الحرية الشخصيَّة، وألصقوه بالمدنيَّة.
كما أن مصدر هذا الخطأ هو ما يَراه الناس بأعينهم من اهتمام الأمم قاطبةً بالمُتَع النَّفسية دون التقيُّد بالآداب التي يحرِّمها العلم الصحيح، ولا شكَّ أنَّ العلم يتَّفِق مع الدين في تحريم الخَمْر، والميسر، والزِّنا، والرِّبا، والمخدِّرات، ولكنَّهم وللأسف الشديد لا يقيمون للعلم وزنًا حين يحرِّم هذه المضارَّ.
وأنهى الأستاذ “وجدي” كتابه بقوله: إذا قام المسلمون بدعوةٍ إلى دِينهم، مؤسَّسةٍ على التَّنويه بهذه الأصول الأوليَّة في الإسلام؛ فإنَّها تؤثِّر في العقول والقلوب بِوَصفين: أوَّلهما: بِوَصفِ أنَّه دين، ثانيهما: بوصف أنَّه إصلاحٌ عالَمي عام، فالإسلام كدينٍ لا يَحتاج إلى أكثرَ من أن يُعرَّف التعريفَ الجدير به[9].
نظرة في فكر فريد وجدي
نلحظ من كتابات فريد وجدي تأثره الشديد بفكر الإمام محمد عبده في محاولاته للتوفيق بين العلم والدين، وهنا يحضرني كلمات الشهيد -بإذن الله- سيد قطب في كتابه خصائص التصور الإسلامي، وهو يتحدث على عدم الغلو في مواجهة انحراف معين حتى لا نقع في انحرافات أخرى، حينها أعطى مثالًا على ذلك بالشيخ محمد عبده وغيره عندما أراد أن يواجه غلو الغرب في العقل وجمود العقل في الشرق، جعل العقل -متمثلًا عند فريد وجدي في العلم- ندا للوحي.
وفي هذا السياق يقول الشيخ سيد قطب:
«إذا أردنا أن نقول إن العلم والوحي لا يتعارضان يجب أن يكون ذلك على أساس أن الوحي أكبر وأشمل من العقل، وأن الوحي هو الأصل الذي يرجع إليه العقل، وأن الوحي هو الميزان الذي يختبر به العقل تصوراته ويصحح به انحرافاته واختلالاته، وأنه ليس هناك عقل مبرأ من النقص والهوى».[10]
حقيقةً، ما جعلني أجنح لهذا التفسير لفكر محمد فريد وجدي، شروعه للتأويل في آيات الله، وهو ما قد ظهر لي واضحًا في تفسيره لقول الله تعالى: (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا، ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم).
فقد قال في عقب تفسيره لهذه الآية: وإن إشارة الكتاب الكريم إلى معجزة إبراهيم هذه تشير إلى أن في الإنسان قوى إلهية في إمكانها، وبتوفيق الله، أن تبعث الحياة في الجمادات وقد دلت الأبحاث في المغناطيس الحيواني في هذا العصر على ما يجعل هذه المعجزة معقولة علميًا![11]
فانظر إلى ذلك التعسف في التفسير وذلك التأويل الذي لم يقل به أحد من المفسرين، في محاولةٍ منه إلى إلباس الآيات لثوب العلم الحديث. فلم أجد تفسير لمثل هذا التأويلات إلا بسبب الغلو في شأن العلم والعقل، ومحاولة استنباط المبادئ الإسلام من بين النظريات العلمية وكلام العلماء.
الخلاصة:
خلال رحلتي المتواضعة والقاصرة أيضًا في كتب الأستاذ محمد فريد وجدي وبين كلماته، ألحظ أنه وقع في معضلة تساوي العلم مع الإسلام، وإن كان كل همه إثبات مدى توافق العلم مع الدين واحتضان الدين للعلم!
ولكن الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه إذا قلنا أن العلم والدين منسجمان، هو أن يكون على أساس أن الدين أعم وأشمل من العلم، بل إن الدين هو الميزان الذي نختبر من خلاله العلم ونظرياته، لا على أساس أنهما متعادلان وأن العلم ندًا للدين، فالإسلام ليس متهمنًا بمعارضته للعلم، ولا قضيتنا من الأساس تكمن في إظهار مدى توافق العلم مع الدين، إنما ما علينا فعله تجاه الدين هو عرضه كما أنزله مشرعه.
وفي النهاية، لم أجد كلمات أبلغ بيانًا لما أود قوله من كلمات الشيخ سيد قطب:
«لابد أن تُعرض العقيدة بأسلوب العقيدة، إذ أن محاولة عرضها بأسلوب الفلسفة -أو العلم كما في حالتنا هذه- يقتلها، ويطفيء إشعاعها وإيحاءها، ويقصرها من جانب واحد من جوانب الكينونة الإنسانية الكثيرة».[12]
[1] رجال عرفتهم |عباس العقاد
[3] محمد فريد وجدي حياته وأثاره|محمد طه الحاجري
[4] بدائع الأكوان| محمد فريد وجدي
[5] الإسلام والمدنية| محمد فريد وجدي
[6] محمد فريد وجدي حياته وأثاره|محمد طه الحاجري
[7] المصدر السابق
[8] مهمة الإسلام في العالم|محمد فريد وجدي
[9] مهمة الإسلام في العالم|محمد فريد وجدي
[10] خصائص التصور الإسلامي| سيد قطب
[11] صفوة العهدان|محمد فريد وجدي
[12] خصائص التصور الإسلامي| سيد قطب